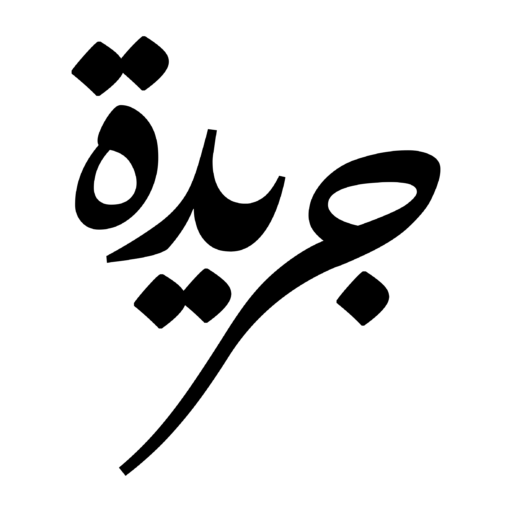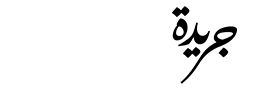لعل مقاربة (المعنى) من أكثر الصعوبات التي يواجهها المتلقي، ولاسيما إن أوشك الكاتب في تقصُّدِ الإرباك أو تشعبية المراد، يتضح ذلك في أعمال بُنيت على تعددية المعنى كما لدى المتصوفة، لكن ماذا عن الرواية التي يراها سهلة وقريبة وواضحة؟
(غرفة الأم) رواية الكاتبة السعودية ليلى الجهني الصادرة عن دار أثر عام 2024م من الأعمال التي يتركَّبُ فيها المعنى بأكثر من طريقة، ذلك أن الكاتبة تحيل على (المكان) الذي يبدو صغيرا، فتصف غرفة ربما لا تتجاوز أكثر من خمس وعشرين مترا مربعا، لكنه مكان جليل القدر في نسبته لكائن كالأم. بينما المكان الذي تشيّده الكاتبة (مكانٌ آخر) أكبر من الصورة المرصودة في العمل.
تصور الكاتبة فقدان عائلة – متشتتة مسبقا – للأم، عبر رحيلها ضُحى أحد الأيام. تجترُّ الكاتبة معاناة الابنة الكبرى من منظورها بحكمها الأقرب شعوراً ومكاناً وشخصاً، مع أنها غادرت المنزل بسبب الزواج وبقيت الأم تسكن المنزل وحدها.
حدثٌ مفصلي هامّ قلبَ حياة العائلة رأساً على عقب قبل موت الأم، من خلال فقدان ابنها البكر ضُحىً أيضاً، وبرحيله عن الدنيا انكفأت الأم على نفسها، وانفصل الأبوان ظاهرياً؛ حيث ابتعد الأب شيئا فشيئاً عن زوجته حتى غادر المدينة برمّتها، ثم غادرت الابنة الأخرى (عالية) للابتعاث، وبقيت شخصيتنا الرئيسة (غادة) ترصد ما حدث وحدها.
بينما هناك مكانٌ آخر يتشكَّلُ على امتداد العمل، مكانٌ عبَّرت عنه الكاتبة بالرمال والسيول والغبار والجبال، وبدت استعاراتها حول الأمر خلاقة وموجعة، تعبّر في أحد وجوهها عن محو الطبيعة لبعض أجزائها وتجددها تدريجياً، فالمتغيرات تحدث بمرور الزمن، لكنَّ مروره ذو وجهين، فإنْ كان الأمر يتمشَّى مع كثيرين إيجاباً بالنسيان والإصلاح، فإنَّ الأمر قد اختبرته العائلة بوجهه السلبي حين لم تتجاوز الأم المأساة، وأبَتْ نسيان ما حلَّ بها حتى صار الموت يقرض أفراد العائلة.
تختار الكاتبة زيارة الموت الأولى للابن (زياد) عبر حادث سيارة؛ إذ تردَّى من أعالي الجبال على طريق سفره الأول بعيداً عن العائلة، ثم تختار موت الأم ويبدو أنه على إثر مرض عارض أصاب الرئة، فتموت وحيدة بعيدة عن سريرها وغرفتها، حيث تقضي أنفاسها الأخيرة في المشفى، فتُصدَم الابنة التي لم تظن الأمر جللاً بهذا القدر.
لا تبدو إصابة الرئة مصادفة؛ العضو الذي يئس من تحسُّس أثر الفقيد، فثراء النص القرآني بالدلالات في قصة سيدنا يوسف عليه السلام يُعلي من شيء ضئيل كالرائحة للمحزون، وفي اللحظات الأخيرة للأم في المشفى لا تنادي سوى باسم فقيدها الذي لم يعد هناك بدٌّ من تحسس أثره سوى باللحاق به. لا تُفلِتُ الكاتبة من يدها أهمية موضوع الرائحة إذ تملأ المكان برائحة الأم؛ فتؤثث غرفتها بها لتؤثر على حسّ القارئ فتستدعي ذاكرته الأنفاس المتشابهة للجدات والأمهات، وما يخترنه عطراً كدهن الورد المفضّل محلّيّاً، وعطور فرنسية قديمة وراسخة من مثل شانيل 5 و anais anais .

من جهة أخرى ينبني مكانٌ آخر ويتشكل على مهل؛ إذ تشير الكاتبة بأكثر من طريقة على تجدُّد (المكان) محليّا بظهور آخرين يقودونه في مرحلته القادمة، ويَفرَغُ رائحةً بانتظار أنسام أخرى تملؤهُ بأشخاصه المناسبين؛ فمَوتُ زياد ورحيل الأب ثم موت الأم؛ كل ذلك ينبئ بانتهاء نماذج وشخصيات تتعلق بمرحلة سابقة، مرحلة اختارتها الكاتبة بعناية وذلك قبل الجائحة بعام، بينما سفر ابنة مبتعثة للدراسة، واختيار الشخصية الرئيسة امرأة تتولى ترتيب المكان كله من جديد، ثم تصفية متعلّقاته ومراجعة الذكريات فإنه يبشّر بمرحلة جديدة. ولعلّ مفارقة التوقيت المتكررة (ضحى) تشير إلى هذا الفقدان والألم عبر الحمولة القرآنية التي يرتكز عليها اللفظ، وما تحيل إليه سورة الضحى من العطاءات والعوض الرباني. ولا أظن الوقت أيضا قد اُختير مصادفةً، فحضور الوقت وتحديده موظَّفٌ بعناية في العمل.
أما العنوان الرئيس فهو يحمل في معان أخرى إشارة لطيفة؛ إذ ترسَّخ في وجدان المتلقي الخليجي شيءٌ آخر متعلِّقٌ بغرفة الأم، فقد أثَّرتْ على أغلبنا الفنانة القديرة حياة الفهد بالمسلسل الشهير (خالتي قماشة)، وكانت شخصيتها في العمل شخصية أُمٍّ متسلطة، تراقب أبناءها وزوجاتهم، وتتحكم في مجريات الأمور بمعرفتها السابقة لما يدور في الغرف من أسرار وأمور. الكاميرات المتلفزة التي كانت تخبئها وراء جدار متحرك هالت المتابع في الثمانينات. ولا شك بأنّ عنوان (غرفة الأم) لافت وجاذب رغم بساطة تركيبه، إلا أنّ خصوصية التجربة لكل منا، واقتحام صور طارئة من الذاكرة والواقع المعاش لا يمكن استبعاده بمجرد قراءة العنوان، فهي تُذكِّرُ بتلك الغرفة بقصد أو دون قصد، وتستدعي معه تجربة القارئ حول ما اختبرته حواسه أيضا وليست متعته الفنية وحسب، فتستند على الحسّ والشعور معا. وهي حين تضع ذكرياتها عن الأم بين عبارة تكررت كثيرا من قبيل: «قبل أن يحدث ما حدث» فإنها تفصل في الغرفة نفسها بين رائحتين، وشخصيتين كانتا معا في الغرفة، وعالمين، وحياتين عاشتهما تلك الأم قبل: «أن يحدث ما حدث» وبعد حدوثه؛ ولا تبطئ الكاتبة بما يبلل شغف القارئ لِكُنْهِ ما حدث؛ فهو يكمن في موت الابن الوحيد، الأمل الوحيد، الذِّكْر الذي سيأتي محله طبيعيا ذِكرٌ آخر ومرحلة أخرى وحضور أقوى للمرأة، بدءاً من أفول غرفة الأم وغرفة التحكم والفكر التقليدي، فهذه الابنة تعي جرح العائلة، وتنهض بالمهمة بعد وفاة والدتها، وأخرى تدرس بعيداً لتأتي بشهادتها الكبيرة… كل ذلك يرسم المكان بشكل مستقبلي وبصورة كبرى تستشرف مراحل قادمة على سبيل التطور والتغيير.
يذكر غاستون باشلار وظيفة مهمة للبيت إذ يحفظ الذكريات من الضياع، أما البيت في الرواية فهو يتعرض للإفراغ من الكلمات الأولى، ويعاني المتلقي منذ أول وهلة تلك المشاعر التي قضت فعلا على أزمنةٍ هامة ومبكرة، وحلَّت بعدها أزمنة أخرى، فقد درج كثير من الناس على تأريخ حيواتهم بالبيت وانطلاقا من البيت، ومهما تغيَّر المكان فإنهم يجددون ذكرياتهم بدءاً منه أو بالانتقال إليه.
إنَّ تلك المونولوجات عالية الحساسية تجاه البيت والذكريات وأهله كانت تنتزع من الوقت حكايته كأنها تتحدث بلسان الكل؛ الكل: إنساناً وزمناً ووطناً، من خلال معنى قريبٍ أولاً، حيث الرواية عن أُمّ مفجوعة، أثَّرتْ بحزنها على عائلة كاملة، فعادت الابنة إلى المنزل بمفردها لتواجه كل ذلك الأسى وتضع الحدّ له، والمعنى البعيد ثانياً؛ إذ تُورَّخ فيه الكاتبة شيئاً من حكايةِ وطنٍ يريد العيش في زمنٍ مُفارِقٍ بما يؤهله لوضع نقطةٍ آخر السطر، وبدء شيء جديد. إنها صورة مركبة من زمنين ومكانين وأجيال بينهما. وهذا العمل يقبض على اللحظة المناسبة ببراعة.
لقد عادت غادة إلى المنزل لتضع هذه النقطة بعد أن غادرته، وأذكر قولاً جوهرياً لعبد الفتاح كيليطو حين ذكَرَ عدم وجود كنز في المكان الذي نعتقد وجوده فيه، فالأحلام والمخطوطات لا تدلنا على أمكنة الكنز الصحيحة، وأن علينا تدقيق النظر في هذه الفكرة التي تدعو للذهاب بعيدا للبحث عن الكنز، بينما الكنز موجود في البيت، إنما تجب مغادرة المنزل والتقاط خبر موضعه من مكان آخر. ربما شيء من هذا حدث بموت الأم وعودة الابنة لترتيب الحياة مجددا بعد مغادرتها لبيت الزوجية… لعل كثيرا منا يلتقط حكمةَ كنزِهِ الخاص بعد أحداث تدعو للرحيل والعودة مجددا، ولعلَّ الغرفة في هذا العمل ليست مجرد غرفة تُفرَغ من صاحبها وأشيائه…
أتذكر حواراً طريفاً عن الغرف جاء المسلسل الطبي الشهير doctor house، بينه ومريضة تعرضت لصدمة جراء اعتداء جنسي؛ تطلب منه رواية قصة خاصة، ثم تتساءل عن مدى صحتها، فيخبرها بأنها (حقيقية) لأحدٍ ما. تستاء المريضة لأنه لم يخبرها قصة خاصة به، فيُعلّق على حديثها بأنَّ هذه الأشياء تحدث فعلا، ولا يهم إن حدثت له أم مع غيره، فترد عليه “بحاجتها لقصة حقيقية حدثت لأحد في هذه الغرفة التي يجلسان فيها“، فيصرخ بها قائلاً إنهم في الخارج، بعضهم على ما يُرام والآخر في حال مزرية، ويسألها مستنكراً إن كانت ستبني القادم من حياتها على أشخاص معها في هذه الغرفة، فتجيبه بأنها ستبني اللحظة على الشخص الموجود معها متذرَّعَةً بـ “أنَّ هذه الحياة ما هي إلا مجموعة من الغرف، ومن نبقى معهم في الغرفة ذاتها هم من يضيف المعنى إلى حياتنا“… فهل قصدت الكاتبة ذلك في المعنى البعيد للرواية؟ هل جعلت الأم ترحل من الغرفة ويُفرغ البيت لتُسلِّمَ المكانَ حياةً جديدة فعلا؛ حياة ستحدِّد المعنى بما اختارته من شخصيات تبقى في المكان؟
لعلَّ القارئ سيُفاجأ بملحمة كاملة لا تزيد عن ثمانين صفحة، مكتوبة بعذوبة ودنوّ حميم من القلب، ستلمس فيه شجناً تجاه شخصيات وأمكنة وأزمنة بعيدة، ولعله يجد معنى آخر لم أفطن إليه، فالأعمال العظيمة مقتصِدة في التعبير، أما المعنى فلا.