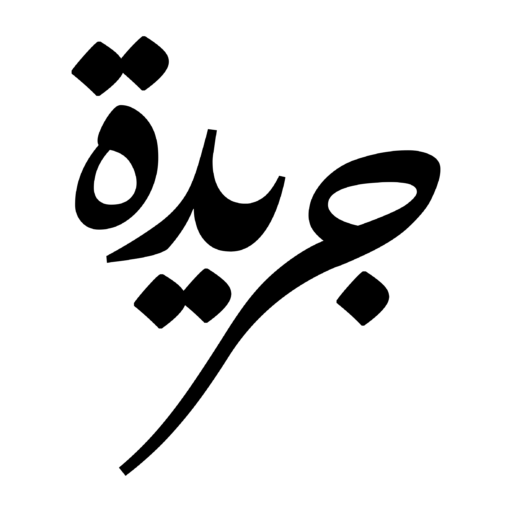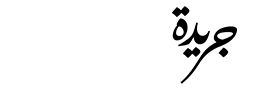كنت في الثانية عشرة، أو ربما الثالثة عشرة من عمري، عندما كتبت أوّل ما سمّيته “قصيدة”. كانت قصيدةً عن أطفال الحجارة. أذكر أنني علّقتها بفخرٍ على لوحة مجلة الحائط في مدرستي، ومن أبياتها التي لم تفارقني:
“طفلٌ بيدهِ مدية
صفحةُ رملٍ رطب..
هو يكتب..
أيدري ما يكتب..”
كانت تلك الكلمات جزءاً من قصيدة تحكي عن حجرٍ نحتهُ البحرُ سكيناً، ليغدو قلماً يخط به طفلُ فلسطينَ التاريخَ الوحيد الصادق على وجهِ الأرض حيث اجتمعت براءة الطفل مع جبروت النّصل.
يبقى السؤال الجوهري: لماذا يضطرُ طفلٌ إلى حملِ حجر؟ لماذا لا يُتاح له أن يحمل حجر اللعبِ الذي كنا ننتقيه بعناية في صغرنا لنلعب “الحجلة” ونتبارى من يصل إلى “الجبل” بقفزةٍ واحدة؟
لطالما كان القلم وسيلة الطفل الأولى لكتابة كلماته البسيطة: “بابا”، “ماما”، “وطني”. اليوم، إنْ سَلِمَ الطفلُ من بشاعتنا ـ نحن ”الراشدون” ـ فلن تسلَمَ كلماتُه الأولى، ولن يعاني في تهجئة حروفها، لا سيما حرف الألف، العصا الطويلة التي لم تعد حرفاً بل عموداً يعاندُ جنونَ الريحِ والنار والموت تحتَ أسمالِ خيمةٍ ووسطَ الكثيرِ من الأشلاء.
لو كنتُ هذا الطفل فهل سأكبرُ لأبحث عمّن يقرأ كلماتي المنمّقة؟ لا أعتقد.
ما الذي نرجوه من أطفالٍ يتعكزون على بعضهم بعضاً؟
صورة لطفلة لم تتجاوز الثامنة، تحمل على ظهرها أختها الصغيرة، تسير حافية القدمين بحثاً عن ملاذٍ في خيمة!! تسيرُ وحدها في مواجهة كوكبٍ غارقٍ في توافه الأخبار؛ فقد صدرت آخر نسخةٍ من الآيفون، وخسرَ نادٍ أمام آخر، وأعلنت شركات عن حسمٍ 80٪ على منظفات المطبخ.
في الأدب، تنهمر دموعُ الكتّاب والشعراء غزيرةً على أوراقٍ تروي مآسي الموت والنزوح والخيبة. ثم تُطبع كتبهم، وتزيّن المعارض والمكتبات، وتُلتقط بجانبها الصور مع فناجين القهوة الحالمة. والطفل الجائع يحمل طبقاً بلاستيكياً في انتظار أن يمنّ عليه بطلُ حقوق الإنسان بفتاتِ الخبز أو حبةَ بندورة حمراء.
– “أمي، أريد قضمة من حبة البندورة الحمراء التي كنتِ تغنين لي عنها كي أتوقف عن البكاء. الآن، أبكي يا أمي، لكن لا أحد يسمعني. صرتُ بلا اسمٍ، مجرد نازح، لاجئ، يتيم. هل تذكرين اسمي يا أمي؟ إن لم أسقط في مصيدةِ الأرض المفجوعة هذه، ربما سأكبر وأصبح لاجئاً في بلادهم البيضاء ويغدقون عليّ بدموع تماسيحهم.
عقول البشر اليوم تظهر قدرات خارقة في تجاهل الواقع والانغماس في اللامبالاة، وكأنهم اخترعوا آلة الزمن أخيراً وعادوا إلى عصرِ أمجادهم، زمنِ الجاهلية. عصر الفساد والمال. يقالُ إننا أبدعنا حينها في الفسق والفوضى. كم عقداً تحتاج البشرية لتستعيدَ توازنها ويستعيد الطفل حقّه في الحياة والأمان وأناشيد أمّه وظهرَ أبيه؟
إنّ من بقيَ لديه ذرةٌ من وعي أو إيمان مطالبٌ اليومَ بالنظرِ في حالِ هؤلاء الأطفال الذين ألقينا بهم في أتونِ الصدمات والعقد النفسية. نحتاجُ خطة علاجية ترمم الشرخَ الخطير الذي قصم ظهرَ الأجيال في هذا العصر الأسود.
نحتاج جيشاً من الأدباء والمفكرين يهبطون من علياء أبراجهم العاجية ويتنازلون عن حشودِ المعجبات واللايكات، ليكتبوا أدباً حقيقياً ينكأ الجرحَ ويكون لهُ بلسماً في آنٍ معاً.
نحتاج جيشاً من الحكماء يقودون الوعي نحوَ نور المعرفة، لا نحوَ شاشاتِ الموبايلات وحصص الدروس الخصوصية.
نحتاج أن ننهض ببقايا الأبِ والأم ونمنحهم الماء والخبز بعدلٍ ودونَ منّة. على أملِ أن يستوي هرم ماسلو وتُلغى قاعدته الجائعة الخانعة، فيغدو عقل الطفل في سلام، منشغلاً بالإبداع لا بالصراع.
الطفل، لو تعلمون، هو رسالتنا الأسمى في الحياة، وسببٌ من أسباب خلقنا ووجودنا على هذه الأرض المسكينة. سخروا علومكم في سبيل علاجه من صدمتهِ بالإنسانية بدلاً من اختراع شاشةٍ جديدة وقيدٍ جديد. سخروها لتشفي جراحه بدلاً من أن تكون وسيلةً وحشيةً لقهره.