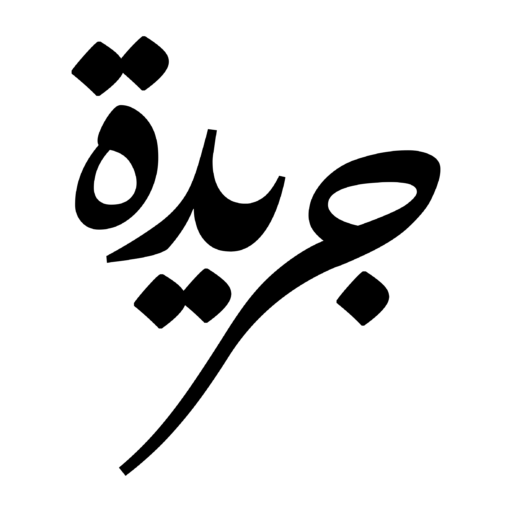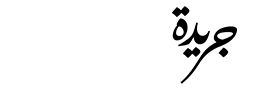في طريقي إلى جريدة أخبار الأدب، ضللتُ طريقي كالعادة. وجدت نفسي أمام مسرح يحتل ناصية الشارع اسمه “الهوسابير” ومعلّق على يمينه ويساره إعلانات مسرحيتين للأطفال، واحدة عن “شركة المرعبين المحدودة” والثانية “السنافر”.
أكره تصميم السنافر الثلاثي الأبعاد الذي يعلنون به عن رفقاء طفولتي. أرى في تحويل كل ما كان ثنائيَّ الأبعاد إلى ثلاثي أبعاد محاولة يائسة لجعل حياتنا مثالية، فتفقد بذلك روحها الإنسانية التي نشأت منها. أفكر أنها خطوة جديدة من استوديوهات هوليوود لجني أموال من رموز طفولتنا التي كبرنا معها.
النشأة
ابتكر شخصية السنافر، الرسام البلجيكي “Peyoo” في خمسينيات القرن الماضي، 1958 بالتحديد. بدأت مجلةً للأطفال، ومع الوقت اشتهرت حتى حوّلتها شركة أميركية في 1981 إلى مسلسل للأطفال استمر حتى 1989. راج المسلسل الأمريكي، وتبنّت دبلجته إلى العربية شركةٌ لبنانية. لاقى نجاحاً باهراً وانتشر عبر التلفزيونات وشرائط الفيديو حينها في التسعينيات. صار منافساً قوياً لمسلسلات عدة مثل “سلاحف النينجا”، “دراغون بول”، “توم وجيري” وأفلام “ديزني”.
التفاصيل الفنية والتاريخية
فضلت دوماً مشاهدة السنافر في طفولتي لحبي للون الأزرق. أرتاح لمشاهدة تلك الكائنات الزرقاء التي تحيا في بيوت من المشروم وتتعاون لإفشال خطط “شرشبيل” الشرير. أتذكر إحدى الحلقات التي حاولوا فيها إحباط خطته في سرقة هدايا عيد الميلاد “الكريسماس”. نجحوا بالتعاون معاً وبمساعدة بابا سنفور. لم أحب يوماً شرشبيل أو قطته وظللت لفترة طويلة في طفولتي أكره القطط السوداء.
تزرع قصص السنافر في الأطفال العديد من القيم الإيجابية كالتعاون والصداقة وفوائد العمل الجماعي، بشكل بسيط ومباشر على عكس ما يعرض حالياً في قنوات الكارتون المختلفة. أثبتت السنافر الثنائية الأبعاد مع مرور الزمن قدرتها على مقاومة التيار والاستمرار، وتحولت من شخصيات كارتونية بسيطة إلى رموز ثقافية عالمية.
السنافر بين الماضي والحاضر
حين شاهدت إعلان فيلم السنافر في 2011 وعودتهم إلى الشاشة الفضية بفيلم، تحمست للغاية. دخلت الفيلم بمجرد نزوله، لكنني سرعان ما أحبطت، ليس بسبب الحنين إلى الصورة الثنائية الأبعاد أو إلى أجواء مشاهدة المسلسل العائلية الدافئة على عكس قاعة السينما المكيفة الباردة. لكن لابتعاد الفيلم عن الروح الأصلية التي بدأ منها المسلسل.
شعرت لوهلة أنه مجرد إعلان كبير لـ “كاتي بيري” أو في الجزء الثاني عن أغنية جديدة لـ “بريتني سبيرز”. اختفت السنافر ببراءتها التي اعتدتها، فشلت في متابعة سير القصة البسيطة التي ترويها الأفلام. لم أرى أي تطور للشخصيات الثانوية في الفيلم أو حتى تغير في أي من رحلات الأبطال. سألت العديد من مشاهدي السنافر الأوفياء، وشاركني معظمهم الرأي.
السنافر عبر الأجيال
استعنت بأحد أصدقائي ممن هم في عقدهم الخامس، الذين عاصروا السنافر بوعي في أوج شهرتهم وعن تجربة أطفاله الحاليين مع مشاهدة السنافر. تمحورت أسئلتي معه إن كان قد شاهد الإنتاجات الهوليوودية الأخيرة واستمتع بها مثلما كان يشاهدها على التلفاز.
أجابني بتلقائية:” هي حلوة لكن طويلة أوي“. ثم أوضح أن قصص السنافر لا تحتاج لرحلة درامية محبوكة كي تصل للأطفال، فهي مصممة في الأساس كي تمتعهم وتعلمهم الفروق الواضحة بين الخير والشر. ملَّ أطفاله وهو من الفيلم لطوله المبالغ فيه وتعقيد حبكته.
كانوا يفضلون رؤية شرشبيل في أحد الحلقات يختطف سنفورة، فيخترع سنفور العبقري أو “عبقرينو” شيئاً يعيدها إلى أحضان المجتمع السنفوري ويفرح الجميع في النهاية. لا حاجة لتحميل القصة بشخصيات نسائية أخرى أو فرض أي أجندات خارجية على القصة كي توائم اتجاهات المجتمع أو الاستوديو المنتج للفيلم.
المسرحية
انتهيت من مشواري في ”أخبار الأدب“ ودفعت خمسين جنيهاً ثمنا لمشاهدة العرض المسرحي. كان المسرح مزدحماً بأمهات وأطفالهن. صمت الجميع لحظة ظهور الممثلين مرتدين ملابس السنافر عكس ما توقعت.لم يدم العرض أكثر من نصف ساعة. تمحور حول قصة تقليدية لخطف شرشبيل لأحد أعضاء السنافر من أجل إجراء تجربة مجنونة عليه، ثم إنقاذ السنفور في النهاية. استمتع الجميع بما فيهم أنا على الرغم من إمكانيات العرض الضعيفة سواء من إضاءة أو ديكور، لكنهم استغلوا المساحات ومقوماتهم بشكل ممتاز.
بعثت لصديقي بعنوان المسرح ومواعيد العرض كي يصطحب أولاده إليه. فضّلت سنافر الهوسابير على سنافر هوليوود، وأتمنى دوام تلك النسخة عبر الأجيال.