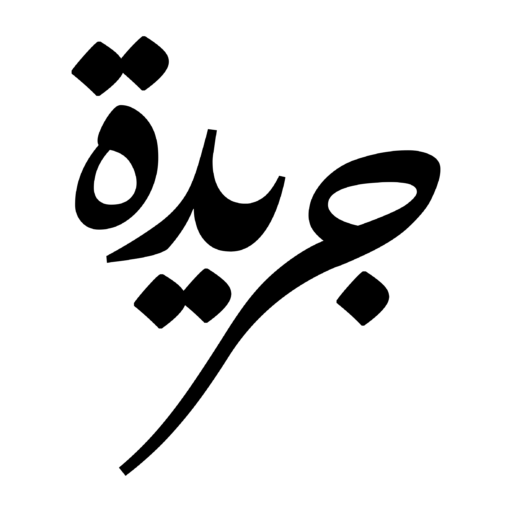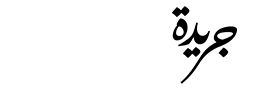عاد الجمهور لرشده في اليوم التالي ولا يعرف ماذا حدث، لكن دموعهم اختفت وجلجلة ضحكاتهم بُحّت، ومشاعرهم أصبحت باهتة، كان كل واحد يتلفت إلى جواره ولم ينبهه إلا هاتفه وعشرات المحادثات القلقة عليهم من جراء اختفائهم غير المبرر. لكنهم أجمعوا أنها تجربة لا تنسى وهرعوا إلى صاحب دار النشر في تدافع يغلفه الذعر، من فرط النشوة التي تشتعل في أجسادهم، لحجز جلسات القراءة لأي كتاب ستقرأ فيه تلك تلك.. واكتفوا بتلك عندما خارت ألسنتهم عن الوصف، وظلت التفاصيل محبوسة بين فك كل واحد منهم كأنها لجمت بحراس أشداء.
العشرون من كل شهر كان يوماً ليس عادياً بالنسبة لها، كان يعج بالحركة والنشاط على غير العادة، كنت لتظن أن جميع أيامها جنائزية، لولا هذا اليوم الذي يعبر من خلالها بفرح وابتهاج لطيفين، غير ذلك، الأحداث متشابهة، تستقل عربات المترو المكتظة حيث تختلط الأنفاس والقصص وتذوب المسافات، تختار عربة النساء لأنها أكثر أماناً وأكثر حياة بالتفاصيل، فالنساء يخلقن الضحكات من رحم المآسي، هكذا هي طبيعتهن، توارب كل واحدة مشكلتها الخاصة وتدلقها أمام الغرباء لتتفكه عليها وتنسج النوادر منها، في رغبة متواطئة منهن لسرقة لحظات راحة من إرهاق الأيام العادية الطويلة.
كانت العربة في أغلب الأحيان مزدحمة وخانقة، تحمل وجوها موصومة بآثار ضارية من زمن مجحف، فشلت أدوات الزينة في إخفائها، تأملت خارطة الوجوه أمامها، كحل تسرب في خطوط دقيقة على وجه إحداهن، وتشققات أخرى في طبقة كريم الأساس على وجه أخرى حاولت جاهدة أن تخبيء أرضاً عطشى لشربة حنان وتربيتة كتف.
والجفون المتكرمشة تحت كومة من مساحيق التبرج، تفتح آفاقاً من الحيوات التي تستطيع قراءتها بكل سهولة، لتتوالى الأحكام في ذلك، هل تتقن هذه السيدة فن التبرج أم تحاول يائسة وتتعود يدها على التجمل بيد مرتعشة لتخفي آثار معركة خاسرة تخوضها يوما إثر يوم. تدرك من سحنات الوجوه أعمارهن المخبأة بعناية وراء قناع تختلف جودته حسب المستوى المعيشي، لم يخف على يقظتها المتوهجة وجه فتاة منكب على شاشة الهاتف، تراسل صديقاً لها وتتأمل أن ينتظرها في المحطة المقبلة بقلوب متطايرة أرسلتها في نهاية المحادثة، وأخرى تنشغل بقراءة كتاب عن البنيوية الحديثة، لكن لو اقتربت منها ستجدها منغمسة في رواية عبير التي تخبئها داخل الكتاب خوفاً من الحكم على ذائقتها، والتي تشبع من خلالها جوعاً ضارياً للرومانسية.
وامرأتان تتحدثان عن أزمة اختيار طبق اليوم الذي ستطبخه لأسرتها، ويلعنان أبو الحال وقصر اليد التي تجعلهم يأكلون اللحمة ثلاث مرات فقط في الأسبوع، لتتساءل “هي” باستنكار: هل العالم تغير؟ كانت الناس تحمد ربها على وجبة لحمة يتيمة فقط في الشهر، لتذكر نفسها أن أخلاقيات العالم تغيرت و”هي” في معزل عنهم جميعا.
وقفت بجوارها فتاة يتضح من مظهرها أنها جامعية، كانت ترفع بنطالها ببطء لتكشف عن قدمها ونصف ساقها لتعرض على صديقتها حذاءها الجديد الذي اشترته عبر الإنترنت، ودفعت مقابله مبلغاً طائلا لأنه تقليد ماركة شهيرة.
ولكن في غيمة في الأفق هناك تُودِع سراً آخر طيَّ الغيم، سبب آخر يجعلها تنزوي في عربة المترو المخصصة للنساء، أن تهرب من “أعين الرجال” وتفحصهم لها، واقتحام مسافة الأمان، فقصر المساحة بين كل راكب يجعلها تحت المجهر، والعربة التي تتسع للعشرات يحشر فيها المئات بسهولة ويسر حسب قانون العادي. في اليوم الذي يعاندها حظها وتستقل العربة مع الرجال، يشغلها تفكيرها بجسدها عن مباهج اليوم المنتظرة، وتجلس تفكر فيمَ يفكر الآخرون في جسدها ومظهرها، إذ تظهر في عين هذا الرجل الشفقة على حظها المتواري خلف نحافة جسدها غير المبررة مثل الخشبة، واختفائها في جلباب أسود واسع، ووجهها الذي تتدعي أنها تريد الاحتفاظ به بريئاً دون مواد تجمّله وتغير ملامحه بينما هي في الأساس لا تمتلك أدوات للتبرج ولا تتقن وضعه، تلعن حواجبها الكثة المبعثرة التي ورثتها عن أبيها، ولا تفلح المزينة في جعله جذاباً.
يا لها من مآساة أن يجعل وجودك وسط حفنة من الرجال، مدعاة للتفكر في جسدك وعدل الخالق في منحك جسداً كهذا!
تلك الأفكار التي تسيطر عليها وهي تتجنب النظرات المشمئزة من مظهرها المهمل، أو النظرات غير المبالية بها، والوجوه الأخرى التي لا تراها، تجعلها تنشغل عن تدريباتها اليومية التي تحرص عليها وتنفق عليها الكثير من الأهمية والوقت، وهي أن تمسك بمنديل ورقي وتنفخ فيه كل مرة دقيقة كاملة حتى تتطوع أحبالها الصوتية كما يحلو لها. – كل تلك الأفكار يختفي معظمها عندما تكون في عربة النساء-.
في هذا اليوم في العشرين من كل شهر، فضّلت أن توفر على نفسها عناء اجترار المهانة، وتركز على صوتها، بعد أن غافلها تركيزها في ألوان العربات ووجدت نفسها في مهب الرجال ففصلت نفسها عن المشوشات، وأخذت نفساً عميقاً، سعلت على إثره من الروائح العفنة الناتجة عن التكدس، ولفظته زفيراً لمدة دقيقة، فاليوم حافل ومهم وكانت تنتظره منذ مدة، فعندما هاتفتها دار النشر وأخبرتها عن المؤلف الذي سترافقه كادت أن تطير فرحاً، لمعرفتها بجودة كتابته ووفرة المشاعر في كلماته، وكان فرحها بالغنيمة المؤجلة سبباً في لسعات السعادة التي جعلتها تقفز في نوبات رقص جنوني كالممسوسة.
تجهزت بلباسها اليومي المعتاد وسربلت به قامتها فارعة الطول، وزمّت حجابها الذي يأكل نصف وجهها، ومررت كفها على ملامح بشرية تؤدي الغرض منها، هبطت من العربة وارتقت السلالم لتنهمر في الشارع الرئيسي بتفاصيلة المزدحمة، مشت يميناً باتجاه المركز الثقافي الذي يستضيف الكاتب المشهور في إحدى جولاته التعريفية بكتابه الجديد، كانت خطواتها تتراقص في نشوة تلفها وحدها، فهي تقترب من أن تمتلك العالم بصوتها، ولجت المركز الثقافي واستقبلها صاحب دار النشر بخطواته السريعة وهو يصرخ وفي وسط لهاث أنفاسه سألها:
أخيراً أنت هنا؟؟
تلفتت يميناً ويساراً وأجابته بتلعثم :
نعم أنا هنا؟ هل تحدثني أنا؟
أجابها بقلة صبر:
أجل أنت وهل هناك أحد غيرك هنا!
تداركت الموقف للحظة وصمتت، صوبت إليه نظرة حادة مع رفع حاجبها الأيسر، أصبحت الأجواء مشحونة بإنذار صامت قابل للانفجار، وكان تململ جسدها المفاجئ ينذر عن موجة حنق تطفو على وجهها، فهي تفقد ثقتها في نفسها والعالم كله إلا ثقتها في دقة مواعيدها وقيمة صوتها، فأسرع يعتذر على رعونته وهو يحرك يديه بعشوائية
أعتذر لكنك تعلمين أهمية هذا اليوم!
غمغمت برد لم يسمعه ولم يهتم به، المهم أنها أتت.
دخلت القاعة بخطوات تجاهد أن تكون واثقة لكنها تشعر برعشة في ساقيها، وتحاول أن تتملص من الترنح الذي يفترسها عندما تمشي أمام جمهور القاعة، واليوم تحاول ضعف جهدها لاكتظاظ الغرفة بأعداد غفيرة، نظر إليها الكاتب الذي أخذ مكانه بجانب وكيل أعماله مع مسؤولين في دار النشر، رمقها بنظرة عكست خيبة الأمل، والإحباط، ومال على وكيل أعماله يبثه خوفه من مقدرتها على قراءة أجزاء من أعماله، وهو الأمر الذي اقترحته عليه دور النشر على غير العادة، فغالباً مؤلف الكتاب هو الذي يقرأ ما كتبه ليشارك إحساسه مع مريديه، لكن الناشر هذه المرة وعده بتجربة فريدة ومميزة، فوافق على مضض وبامتعاض سافر.
في خجل زائد تناهى إلى سمعها طنين كلماته التي غرزت السكاكين الباردة في صدرها مع كل مقطع تلتقط فيه أذنها صوت فحيح الكاتب، ليبث مخاوفه، فأحجمت عن إلقاء بعض الكلمات عليه، يكفي أنها تمسك بالكتاب وتشدو، وسيكون الرد وقتها “الهسهسة” التي تهش بها الأعداء من حولها، ليكشف سرها.
جلست على كرسي أصدر أزيزاً خفيفاً لاحتكاكه بأرضية المكان، وبعد إسراف أبله للوقت في بعض المقدمات والحشو المعتاد بالنسبة لها من منظمي الفعالية، جاء دورها، فأمسكت المايكروفون وأخذت بتلابيب الكتاب الذي ستقرأ.
حملقت في الأعين الشاخصة أمامها، في الصف الأمامي رأت الفتاة نفسها التي كانت تراسل صديقها الذي يجلس بجوارها ويحمل في يديه دبدوباً لون قلبه أحمر، وعلى يسار الصف الثالث لفت انتباهها الفتاة التي كانت تقرأ رواية عبير في الخفاء كانت تبحث بعينيها الحالمتين عن الفارس الذي تمتطي الحصان معه ويخطفها من غرفتها الخاوية، وافتر ثغرها عن ابتسامة انطفت قبل أن تتشكل ملامحها من صاحبة الحذاء المقلد وهي تجلس وتضع ساقا فوق الأخرى ليصبح الحذاء ملك المشهد.
أغمضت عينيها وأجبرت نفسها على تذكر ملمسه، والحفيف الذي أصدره تحت يديها، الكتاب الأول الذي أفضى لها بالسر، حروف اسمه تتراقص أمامها “عندما تعشوشب الصخور” ظهرت الصفحة الأخيرة البالية، تلك الكلمات التي حفظتها عن ظهر قلب لمعت بلونها الذهبي ورددتها سبع مرات في سرها، “بحق السر الأعظم أتحكم في العقول/ أتحكم في الأفكار/ أتحكم في الإرادات” ودلفت، وقرأت، ثم تركت القاعة في خطوات واثقة، فالمرأة التي خرجت الآن، ليست تلك الفتاة المرتجفة التي دخلت القاعة قبل ساعتين.
الخميس 23 من يناير في عام ما، كان الجمهور في صدمة لم يفق منها أيام، حيث أقسم كل واحد فيهم لعائلاتهم وأصدقائهم أنه رأى ذاكرة الصوت، تحسسها بيديه العاريتين، واستطاعوا أن يقبضوا على طعم الألم، وشعروا بمرارة العذاب في حلقهم، وهرسوا الشوك بأقدامهم فتنافر الدم منها، وتخلل ذاكرة الصوت فرحاً شربوه تماماً كان حلو المذاق، كان طعم القبلة مطبوعاً على شفاههم لأيام متتالية، في وقت الحب فاض قلبهم حيث أقسم واحد من الجمهور وسيل من الدموع يندلق من عينيه أن قلبه فاض حباً لأول مرة، واكتشف “الفيض”، كان صوتها ساحراً تستطيع بتقلباته أن تلعب بهم على حبل المشاعر جيداً، وتعرف رغباتهم وتوجهها، كانت تتلاعب بهم دون رحمة أو عناء يذكر.
وذات مساء بعد العشرين من كل شهر كانت تشعر فيه هي بالانزواء الهائل وانزياح روحها وامتلائها بالخواء حد الحاجة، وأن الظلام يتربص بها، وأن صوتها لم يعد يربض تحت سيطرتها، وكأنه.. كأنه يستولي على ذاتها ويقتات على مكنوناتها، فاقدة جزءاً من نفسها.
كانت تفتح حقيبتها التي لم ينتبه إليها أحد، وتخرج دموع “فتاة” من الجمهور تأوهت من روعة الإحساس وتدفقه، فترتشفها جرعة واحدة، وتأخذ ضحكة صافية لشاب كان يشبك يديه في يد حبيبته لتربّت بها على قلبها، وتتغلب على الأوجاع الحميمة التي تقض يومها، وتعوم فوق الأشياء والحياة لمساء آخر تقضيه في المهمل.