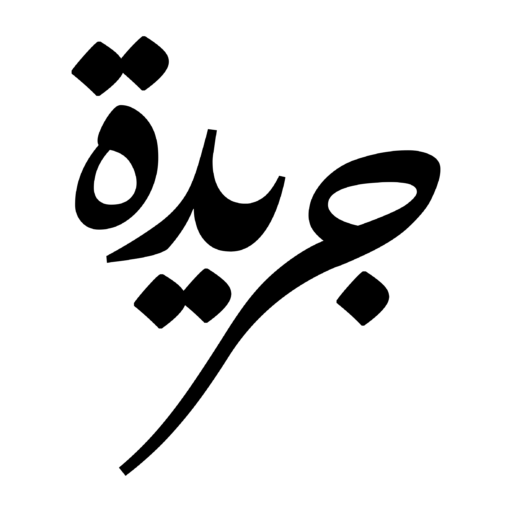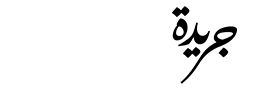أضع آخر قطرات الزيت على طبق الفول، فيقول لي أخي معاتباً: ليتك أحضرتِ معك الزيت من القدس، ها أنت ترين فلا زيت ولا زيتون هذا العام! استشهدتْ كل بيارات الزيتون في غزة.
ابتسمتُ وبيدي عرق الزيتون الأخضر، وقلتُ له: يكفي أن هرّبتُ هذا من القدس! يكفي أنني هرّبت غدي من الأمس!
لقد هرّب الفلسطينيون على مدار عصورهم أحلامهم، هرّبوا من شقوق السجون قصائدهم ورواياتهم، لقد هرّبوا الزّعتر والليمون والتراب المقدسي والهواء، هرّبوا الزيت والزيتون والأيام والآمال، حتى إنهم هربوا الزمن..!
أمّا أنا فقد هرّبت من القدس عرق زيتون لأزرعه في غزة!
فتحتُ باب الحاكورة لأطمئنَّ أن عرق الزيتون المقدسي لا يزال بخير،، لقد أعادني عِرق الزيتون هذا إليك، فهل ما تزال تذكرني؟
حينما زرتُ القدس في أيلول الماضي، وقفتُ أمام جبل المكبر، لا أدري لماذا كنتُ أتوقع منكَ أن تخرجَ من ضوء أحد الأبواب المقدسية القديمة، وأن تقول لي: هل أتيتِ كرؤيا قديمة؟!
لا أدري لماذا كنتُ أمتلك الشعور بأنني أريد أن أكتب ملحمتي “جلد المدينة الحجري”؟ على يدي ووجهي، وعلى الجبال، وعلى وجوه العابرين كي تقرأها الكائناتُ؛ فلا تُنسى!.
وقفتُ أمام الجبل، وأنا أتذكركَ وأنت تقول لي: رأيتُكِ في المنام، تلبسين ثوباً مطرزاً بالأزرق السماوي، كنتِ تزرعين شتلة زيتونٍ على جبل المكبر، كنت تمدّين إليّ يدكِ بثقةٍ وتقولين لي اصعد الجبل! ثم تابعتَ حديثكَ يومها: قلبي يقول لي: إنك ستزورين، إذا زرتِ القدس سلّمي لي على عرق الزيتون الأخضر فيها..
ها قد تحققت رؤياك، وها أنا أصعد الجبل أضع على كتفيَّ شال السماء، جذعي جذعُ زيتونةٍ تخطو بثقة الأسماء، ويداي أجنحة الحمائم، أصعد الجبل، بعدما انسلختُ عن عن الطين، وتحولت إلى كائن خرافيٍّ نصفه طائرٌ مائيٌ ونصفه زيتونةٌ من نار، ألم تبصرني وأنا أمدُّ يديَّ إليك! لماذا لا تتناول يدي! لماذا لا تأخذها بيديك وتحوّلها معولًا تهشّم به أبواب السراب، لماذا لا تحوّلها لمفتاح صفرنيوس، فتفتح به أسرار المدينة!
أخبرني! هل أخبرك قلبك المقدسيُّ الغائبُ أنني هنا؟!
ارتفع صوتُ حيدرة: يا مريم! ستمشي حافلة الوزارة تجاه غزة! هيا!
نظرتُ إليه، فقال لي لائماً: أنادي عليكِ! ألم تسمعي
-(عذراً يا) حيدرة، شغلني الجبل، فلم أسمعك..
يعدّل حيدرة نظارته، ويقول لي: يبدو أنك أحببت المكان، سنغادر بعد قليل! ودّعي الجبل!
-أنا لا أريد أن أودّع الجبل، أريد أن أعانق الجبل وأذيب رمله الأسطوري في روحي، حتى تفوح من أصابعي رائحة الزيتون والمريمية والهيل والغار!
توجّه الفتى حيدرة للحافلة، وهو يقول لي بفرح طفولي جميل: انظري! افعلي مثلي واشتري كعكاً مقدسياً وجميداً وزعتراً! سيفرح أهل غزة برؤيته..
أنا لا أريد أن أشتري زعتراً وكعكاً وزيتوناً وزيتاً، بل أريد أن أشتري وجع الشبابيك المغلقة، أريد أن أسمع صوتَك وأنت تقول لي: هكذا (كانت) الرؤيا تمشي زرقاء على زجاج الروح!
مضيتُ تجاه الحافلة التي تنتظرنا قرب باب العامود، نظرت حولي.. أريد أن أتشرّب المدينة حتى آخر رمق، هناك: أسوارُ القدس العتيقة، وقبابٌ على بنفسج الذهول المقدسي، وشفقٌ حليمٌ يكسو غابات السحاب.. وأضلاع الرخام المنحنية عطفاً على أوجاع الحجارة العتيقة، أمشي أمام باعة المريمية والزيتون والليمون والجميد والكعك، وأكاد أسألهم: لديَّ قلبٌ للبيع؟ أريد أن أبيعه مقابل مقلةٍ تطلُّ على مخمل الأزرق المذهّب، من يشتري قلبي؟
ويبيعني شالاً سماوياً على كتف المدينةْ؟
من يشتري عمري، ويمنحني عيون الماندرينا؟
من يشتري روحي؟
فيكون لي ذهبُ القبابِ
ودمعةُ التكوين في عين الأبدْ
من يشتريني عِرق زيتونٍ؟ ويمنحني الأمد
من يشتري… إن شئتُ بيعاً للزبدْ
ومضيتُ تجاه الحافلة المخصصة لنا، وقفتُ لحظةً لأقرأ أسماء الحافلات وخطّ سيرها. شعرت بغصةٍ حارقةٍ في روحي، كنت أتمنى أن أجد اسم غزة بين أسماء الحافلات، وعلى واجهات السيارات، نقشوا على الحافلات أسماء المدن: يافا، حيفا، الناصرة، الرام، نابلس، أم الفحم! ولكن.. لا حافلة تحمل اسم غزة، سائقو الحافلات ينادون: عكا.. حيفا.. الناصرة.. نابلس.. رام الله! لكن لا أحد يقول: غزة! لماذا؟
ينادي عليَّ حيدرة مرة أخرى: هيا!
أعلم أنه ملَّ كثيراً، ولكن كل لحظة إضافية هنا بعثٌ وميلاد!
حملتُ القدس وجبالها في قلبي وركبتُ الحافلة.
كانت الحافلة تسير ببطء محبّب إليَّ، فما يزال لدي الكثير من الحكايات للعِرْق الأخضر! على مهل سيري، فإن قلبي يحب أن يرى الرؤى تطير في شعاب الروح!
يرن هاتفي.. صديقتي هدى المقدسية، تحدثني وأنا عيني على قبة الذهب التي تعلو أكتاف السور!
-أين أنت مريم؟
– سنخرج من القدس
فتلقّفتْ جوابي، وأجابت بلهفة: لم تخرجي بعد إذن؟!
قلتُ لها: أنا على بوابة البلدة العتيقة الآن!
فأجابتني بلهفة: إذن عودي، يريد أبي أن يهديك (تنكة) زيت .. خذيها معك إلى غزة!
ضحكتُ وأنا أقول لها: وكيف سأحملها؟ كيف سأهرّبها من معبر إيريز، صدقيني لا أستطيع!
فأجابتني بلهجتها المقدسية: “أكيد ما بيهونش عليك أبوي يزعل. ما بينفعش أبوي ينحكاله لا، ارجعي خذيها”.
ضحكتُ وأنا أقول لها: كيف بوسعي تهريب (تنكة) الزيت عبر معبر إيريز… أخبري أباك (أنّ) هديته عزيزة على قلبي، وأنني أحبه كثيرًا
فأجابتني مازحةً: لو أنَّ أبي سمع أنك تحبينه كثيراً، لطوَّب لك بيارة الزيتون عوضاً عن تنكة الزيت.
انطلقت مني ضحكةٌ كبيرة، وقلتها مرة أخرى: مجنونةٌ أنت! إذن، أخبريه أني أحبه أكثر.. ثم قلتُ لها: صدّقيني أنا لا أريد شيئاً سوى أن تكون البلاد بخير.
أعادت قولها: اطلبي من سائق الحافلة أن يقف، أنا رأيتُ الحافلة، سأركن سيارتي لأراك!!
نزلتُ من الحافلة، أخذت تجادلني في تنكة الزيت، وكنت أقنعها أنني لا أستطيع، وأن الجيش سيصادرها في إيريز، فتجيبني محاولةً إقناعي: نحن الفلسطينيون هرّبنا كل شيء.. كانت تتحدث، وسائق الحافلة الضَجِر يقول لي بين ثانيةٍ وأخرى: يا دكتورة! أسرعي! لا نريد أن نتأخر! أمامنا حواجز كثيرة! يا دكتورة أسرعي!
لا أدري لماذا عشقتُ المماطلة وهي تمنحني المزيد من ثواني القمح هنا، تتحدث هدى، ويصيح السائق، وأنا أنظر للجبل السماوي الذي رأيتَني عليه أزرع شتلة زيتون! أين أنت؟
نزل سائق الحافلة، بعد أن نفد صبره تماماً، اقترب منّي وقال بصوت منخفض يشوبه النزق: “دكتورة! منشان الله! بسرعة! إذا مغلباكم تنكة الزيت باخذها أنا! خلصوني! قدامنا طريق طويل.. لسة قدامنا معبر إيريز لحاله بدو سبع ساعات..”
ضحكتُ وأنا أقول له: حاضر، دقيقة فقط! اصعد أنت وسألحق بك!
نظرتُ لهدى، وقلت لها: سأكتفي بأن آخذ العرق الأخضر الذي بيديك، وسأزرعه في غزة، سلمي على أبيك كثيراً، وأخبريه أني أحبه جدا!
ضحكت طويلا وهي تعانقني وتقول لي: سأخبره، لا تقلقي!
صعدتُ الحافلة، وهي تلوّح لي بيدها، شعرها المموج الأشقر يلاعبه الهواء، من مرآة الحافلة أبصرتها أخرجت مفتاحها من جيب الجاكيت الجينز الذي كانت ترتديه، ووضعت تنكة الزيت في صندوق السيارة، ثم بقيت واقفةً تلوح بيدها حتى انعطفنا بعيداً عن الشارع.
أنا لن أخبرك عن هدى، ولكن لعلنا نلتقي ثلاثتنا بأبيها الحاج المقدسي الثمانيني الجميل ذات يوم، قبل مغادرتي القدس بيوم واحدٍ كنت في بيتهم الحجري القديم في قرية (بيت حنينا)، كان يريني صور البلدة القديمة في ثلاثينات القرن الماضي، تخيَّلْ أنني كنتُ أراك فيه، في عينيه العميقتين، وفي صوته الهادئ العتيق، هل تعلم أنني رأيتُك في هدوئه وعزلته وفلسفته وحبه للجبال! لقد كان يحدّثني بينما عيناه للجبل! كان يشير بيديه لجبال المدينة ويقول لي: من هناك بدأ الله خلق العالم! من ذلك الجبل! ومن هذه الأرض قبض الله قبضة من تراب وخلق منها آدم! ثم قام مستنداً على يد وحيدته هدى، وهي تمازحه: لا تقل لي إنك تريد أن تصعد الجبل!
نظر إليها ويداه ترتجفان: لا! فأنا الجبل يا هدى! أنا المدينة، أنا أول الخلق آدم! أنا قبضة الله التي أخذها من هذا البلد!
صعقتني إجابته تلك، فقلت له بلا وعي: أنا أحبك كثيراً يا عمّ… وأحب هذا البلد!
ابتسم وهو يقول لي: تعالي معي.. لتحبي المدينة أكثر.. لتري الزيتونة التي زرعتها أمي هناك على سفح الجبل قبل مائة عام!
فتح باب حديقة منزله القديم، ويديه مستندة على هدى، لا أدري لماذا بكيتُ وأنا أرى الزيتون، كأنني لأول مرةٍ أرى العالم، كان يشير بيده للمدينة ويقول بصوت مرتعش: من هنا، خلق الله العالم!
تختفي هدى من مرآة السيارة، ثم ما تلبث أن تختفي أسوار المدينة، لقد أصبحت القدس وراءنا، ومضينا متجهين نحو الجنوب،،،
أخذت الحافلة تطوي الأرض طياً بسرعةً مجنونةٍ ، والسائق يعتذر بين فينة وأخرى قائلاً
– سامحونا يا جماعة! بدي أسرع مشان قدامنا معبر إيريز! إيريز لحاله بدو ساعات طويلة!
تطوي السيارة الوقت، ولكنها لم تطو الحلم! هذه المرة الأولى التي أرى فيها فلسطين، هذه المرة الأولى التي أشاهد فيها القرى والمدن، وأهرامات السرو العالية التي تكاد تعانق السماء، وشموع القمح التي تضيئ الطريق، وأنبياء الزيتون وهم يحرسون ذاكرة الأرض! أرى فلسطين، وأتذكر الجواهري الذي قال أنه يحسد الذي لم ير فلسطين، لأنه لن يعرف الحسرة التي يذوقها من يراها. وها أنا أتجرع الحسرة مرتين، حسرة لأنني أغادر أم البدايات، وحسرة أخرى فإنني قد وصلتُ القدس ولم تكن أنت فيها!
يسألني أخي وأنا أحدثه عن هدى وعن أبيها الجميل.
-إذنْ أنتِ لم تتركي تنكة الزيتون لأنها ثقيلة!
– لم أكن أريد شيئاً، بقدر ما كنت أريد كل شيء، أنا لا أريد تنكة زيت ولا تمثال خشب ولا تذكار ولا صورة، كنتُ أريد من المدينةِ روحها وتاريخها. كنت أحلم أن أطيل النظر إليها حُبَّاً كما يحب الصغار النظر لوجوه أمهاتهم.. كنت أريد وقتاً طويلا أطول من الوقت الذي نستغرقه في الصباح ونحن نحاول أن نتذكر الرؤى. كنت أريدها حلماً وواقعا يا أخي..
أسقي العرق الأخضر الذي يتوسط فناء البيت، لقد كان الشاهد الوحيد على رؤياك، فأين أنت؟ إذا عدتَ للقدس أخبرني، إذا زرت الجبل أخبرني، لأرسل لك طيور المتوسط وزنابق الساحل..
ينادي عليَّ أخي مجدداً: مريم! أنادي عليك ألا تسمعينني؟
– أعتذر! شغلني العِرقُ الأخضر عنك!
– لقد ظلمتِ العرق! ما كان ينبغي أن تحضريه لأن الموت.. لماذا أتيتِ به إلى هنا، أتيتِ به إلى غزة، حيث الموت والدمار، هل تعلمين بماذا يشعر هذا العرق، إنه يوجعه الحنين للجبل، لماذا أتيت به إلى أرض الحرب والموت والدمار؟.
— لأني أردتُ للحلم أن يكون حقيقةً! لأنني أردتُ أن أرى المدينة أمامي.. تخطو على ماء قلبي الزجاجي بلا قدمين!