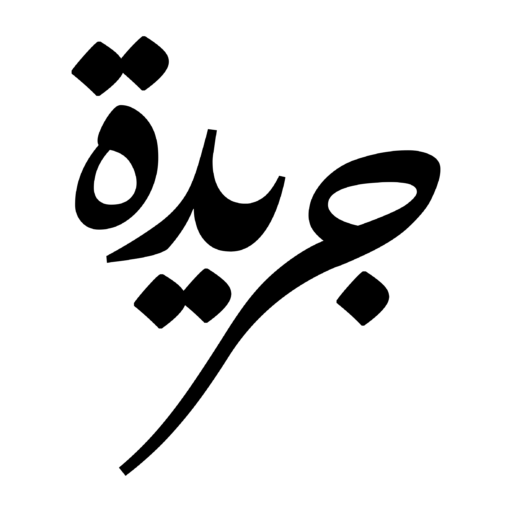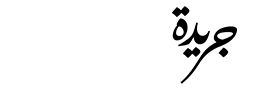أسوأ ما في الأمر أنّي لم أفعل شيئاً، أقف الآن خلف زجاج نافذة عيادتي المطلّة على شارع يأكلهُ الصّمت مع أحذية المارة العجلين، ولعلّهم مثلك يا كارمن، أرواحهم حبالى ولا موعد للولادة.
أغلقت باب العيادة هذا الصّباح وصرفت الفتاة في الاستقبال بحجّة عمل مفاجئ، أبلغتُها ألا تأتي في اليوم التّالي أيضاً، ما الذي كنت أفكّر فيه وماذا أنوي، كان كلّه مجهولاً ورهن عواطف اللّحظة ومواجعها ليس إلّا. خليطٌ من عجز وعتبٍ وحسرة وندم، بل لوم للذات، مع شعور بالقرف من كلّ لحظة كتمانٍ نعيشها معتقدين أنّا نرحم من حولنا أو نجنّبهم المزيد من الألم، وأشياء أخرى لا فئة تندرج تحتها لأصنّفها.
جلستُ خلف مكتبي ثم تناولت المسجّل المخفيّ الملتصق بأعلى درج المكتب، كان جزءاً من خداعي لكارمن عقب أن اشترطتْ عليّ عدم تسجيل ما تقوله؛ لأنّها ستحكي لي كصديق لا كطبيب، آمنتْ ـ ولعلّها كانت محقّة ـ أنّها لم تكن مريضة، إنّما متعبة كثيراً، تحتاج أذناً صديقةً. ناولتُها يومها المسجّل الكبير لتقفله بنفسها وتتأكّد أنّي لن أسجّل، لكنّي خنتُ ثقتها متذرّعاً بنواياي الطّيبة.
تنهيدةٌ عميقة جاءت بداية التّسجيل وضحكة شبه ميتة تبعتها، دُهِشتُ وهي تفصح لي عن نوع المساعدة التي انتظرتْها منّي، وهي أن أجعلها تبكي. تعاملتُ مع طلبها بجديةٍ وحذر ولم أنبس ببنت شفة، تاركاً لها المتّسع كاملاً للحديث. خامرها الشّك ربّما أنّي استخففت بما تقول فأوضحتْ أنّها تشعر منذ مدّة طويلة بشيءٍ جاف في صدرها، أشبه بوجه أرض غطّاها الصّقيع حتّى احترقت، ما عادت تنبتُ حياةً ولا فرحاً ولا أملاً، وأنّها تتعرّض ككلّ البشر لمعاكسات القدر، وتصادف مواقف تنتزع القلب من قفصِ الضّلوع، تُفقد المرءَ صَوابَه، لكنّها لا تحسّ شيئاً حيال ذلك كلّه.
تخجل في مواقف العزاء مثلاً لا سيّما إن كان يخصّ أقرب النّاس إليها إذ تقف تمثالًا، لا دمع، لا حزن يظهر على ملامحها. اعتقدتْ بادئ الأمر أنّها شَجاعةٌ وتماسكٌ وهبةُ الحياة لها أن تغدو صلدةً ضدّ الصّدمات، لكنّ الأمر صار مقلقاً إلى أبعد مدى، ما عادت تفاجأ بأيّ شخص ولا بالمواقف ولا الكوارث أيضاً، إذ الصّمت بضاعة متوفّرة بسخاء، لكنّ الدّمع خؤون بخيل.
سكتتْ قليلاً، أغمضتْ عينيها بشدّة كأنّما تعصر الهواء المحيط برأسها لتسأله شيئاً، انبثقت الكلماتُ فجأة بتحفّظ وخجل بعدها:
ثمّة فوارق بين المشهدين يتجاوز عمرها خمسة وعشرين عاماً لكنّ الألم أشدّ قسوة وحفراً في الدّاخل، الصّفع لحظتها بدا من يدي نحو وجهي، من قلبي إلى صورتهِ في المرآة. أخي الذي يكبرني بسنوات كثيرة لم تكن معيقة للتواصل والفهم العميق بيننا، كنتُ أفهم تسرّعه في اختيار شريكة الحياة، أجد له العذر في بعض ما يمرّ به، مع ملاحظة عدم التّوافق الفكري مع من اختارها رفيقة دربه، لكنّ ذلك كلّه لم يستطع أن يمنحه عندي مبررات للخيانة.
وصلنا ذلك الصّباح مبكرين ومن غير أن نبلغ أحداً أنّا قادمون، وضعتْ أمّي المفتاح في ثقب الباب وراحت تديره على عجل بأصابع مرتجفة حيث الجو ماطر ونسمات موطئة لتساقط الثلوج على أنحاء البلاد، هو جزء من طقوس يناير شهر ميلادي وأسبوع ميلادي بالتحديد، حيث خطّطتُ أن أحتفل به مع الأحبة في اليوم التالي لوصولنا. حرّكتْ أصابعُها المفتاح حركاتٍ سريعة وفي اتجاهات مختلفة كمن يبحث عن سبب منطقيّ لعدم انفراجه والمفتاح هو الصّحيح والوحيد في الميدالية، فلا مجال للخطأ.
لحظاتٌ مرّت محيّرة موجعةً اختطفتْ أنفاس أمّي، ما كنتُ أعي هواجسَها فظننتُ أنّ أحداً ما قد غيّر القفلَ ولم نعلم الأمر، حتّى وجدتُها تطرقه بعنف وتصرخ بأعلى صوتها ليفتحَ من هو في الدّاخل لأنّها ستكسر الباب بالقوة أو تتصل بالشرطة. انفتح الباب شقاً صغيراً كافياً أن نلمح وجود شابّة تحاول ارتداء ثيابها بطريقةٍ هستيريّة، اندفعتْ لحظتها أمّي تحاول إمساكها من شعرها، بينما أخي يمسك ذراعيها لتتمكّن الشّابة من لملمةِ أمرها والانصراف من غير خدوش أو جروح محتملة.
السّنون عدتْ بضراوةٍ وما بحتُ بما جرى كأنّ شيئاً جللاً لم يحدث، لكنّ وجعاً ما، ظلّ ينهش صدري كلّما استذكرت أخي الأحبّ إلى قلبي في تلك الصّورة. ظللت زمناً أحيد عن تفسير مشاعري إن كان يحقّ لي أن أعتب عليه أم على نفسي؛ أن رسمت صوراً متوهّمة مثالية لكثير من الأشخاص والأشياء. لكن … لكن…لكنّي عرفتُ ربما حقيقة ما كنت أحسّه عقب الحادثة الأخيرة، مع اختلاف أبطال الرواية.
اعذر سذاجة دمعي الذي لا يميّز الزّمان والمكان المناسبين للانهمار. آسفة.
خلال خيوط الدّمع ابتسامات كثيرة تسرّبت، شعرتْ بالحرج من سلوكِها المختلط فمسحتْ دمعها بظاهر كفّها وتابعت:
رجعتُ إلى المنزل من رحلة استغرقت أربعة أيّام، بهدف الاستجمام وإنهاء بعض الأعمال على الهامش، ما كان عندي متّسع من الوقت لأبلغ ابني أنّي عائدة، وما عرفتُ التّوقيت بالضّبط فآثرت تجاهل الفكرة. وجدتُ باب البيت مقفلاً، حسبتهُ خارجاً مع صحبه، تناولتُ المفتاح وأدرتهُ بهدوءٍ ثم أدخلتُ حقيبتي إلى البهو، وقعتْ عيني لحظتها على باقةِ وردٍ طبيعيّ على الطّاولة قرب الباب، فحصتها فلم ألحق قراءة ما كُتب على البطاقة المرفقة بها بالإنكليزية، إذ سمعتُ حركةً غريبةً قادمةً من غرفة نومِ ابني، والتفتّ فإذا على المقعدِ حقيبة جلدٍ أنثويّة وهاتفٌ بغطاءٍ ورديّ فاقع، وشال صوفيّ.
ربما لا. لا يمكن! ابني! شيءٌ ما انهدّ في داخلي، ما عدتُ أقوى على السّير صوب غرفته، جمدتُ شوطاً ثم استدرتُ متوجّهة صوب الباب لا أريد الموت من جديد. ألجمني صوتهُ القادمُ من الدّاخل كمن يستغيث كي لا أقتربَ، وأخلعَ القناع دفعة واحدة.
تناولت المفتاح بأصابع يابسة، بل بقلبٍ تصرعهُ قبضة الموتِ البطيء، تركتُ كلّ شيء على حاله ثم أغلقتُ الباب ومضيتْ. لم أشعر أنّي أمّ لحظتها، إنّما كتلةُ غباءٍ متحرّكة، أو جاهلةٌ مخدوعة بقذارةٍ، أنثى ساذجة فاشلة في كلّ شيء، فرسٌ عرجاءُ ودّت لو تعانقُ السّكينَ حيث الرّاحة والرّحمة. لم أقل شيئاً، لم أعاتبْ، لم أسألْ، لكنّ الوقت احترق في رأسي مع ألف ألبوم صورٍ، من طفولته حتّى لحظةِ اندثاري.
مرّ وقتٌ، عاد فيه الصّمتُ يملأ المكان، لا أدري هل انتهى حديثكِ هنا يا كارمن أم أنّ الشّريط انتهى وما وعيتُ ذلك؟ قد أكون شريكاً في قتلكِ، كان عليّ أن أهجّئ الغرقَ في صوتكِ، أن أشعرَ سخونة دمعكِ عبر الأثير.
غرقتُ في صمتٍ أكبر، راحت أصابعي تجوسُ صدري، لعلّها تتوثّق من فينا الذي رحلَ حقّاً.