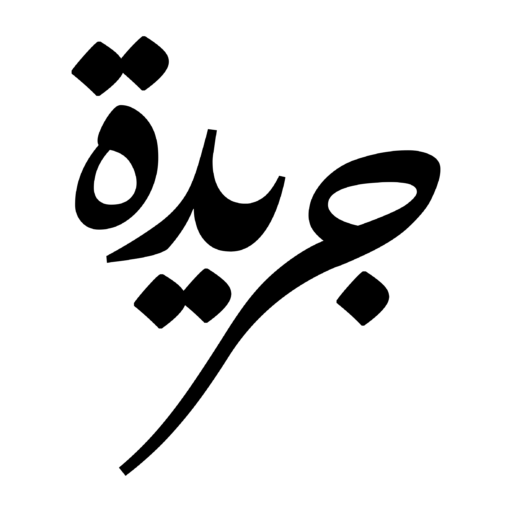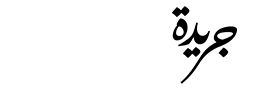“لم أشعر بالفرح عند ولادة ابنتي“.
كانت تلك الجملة التي تفوهت بها صفية وهي جالسة على مقعد مهمل في حديقة ما، لغريب لا تعرف اسمه، كفيلة بأن تجذب انتباهه ويلتفت إليها في نصف استدارة جلسته، تلك الحركة من جسده المحشور في معطفه البالي، جعلتها تدلق مشاعرها لتتخفف منها.
كل أم على ما أعتقد تفرح بالبنت فهي شبيهتها ونصف قلبها، وإن جرت العادة على أن تتشبث البنت بالأب لكن يبقى الحبل السري الذي يربط الأمهات ببناتهن لا ينقطع أبداً، ذلك الحبل الذي يلتف حول مصيرهن كما تلتف ترويسة الشكيمة في رقبة البهيمة، لكن الحبل هنا مختلف لا نستطيع قطعه بسكين أو تحرقه بنار لتحررها، تأبى سنة العادات والتقاليد إلا أن نشد الوثاق حتى لا يرتخي عقالهن، ثم التفتت إلى الغريب فجأة فشعر بالذعر منها، عندما هاله منظر عينها اليمنى التي اختفت منها سمرتها فأصبحت بيضاء كلها، ارتعشت يده التي تمسك ببقايا سيجارة ينفثها في الهواء وهو يراقب سحاباتها المتكومة أمامه، والذي انشغل بها فترة من الزمن، وَوجد نفسه تلقائياً يمد لها بقايا سيجارته فأخذتها بلهفة شديدة، وشفطت كل الأنفاس فيها مرة واحدة وحرقتها مع روحها المحترقة.. سألها مذهولاً: أنتِ مدخنة شرهة؟ أجابته: هذه أول مرة أشرب فيها سيجارة وأشد نفَسَاً، لكن تخيلت نفسي كثيراً وأنا أفعلها حتى احترفتها في خيالي، وأصبحت مدخنة خبيرة ينقصها سيجارة.
كسر الغريب بجوارها الصمت الذي لفته دهشة السيجارة بهما، مبدياً قلقاً عابراً على شريك مقعد، قلق لا يُعتد به في الغالب: “تبدين شاحبة جداً، هل هناك ما أستطيع فعله؟”
“لا أريد خلفة البنات”
جاء صوتها هادئاً ومرعباً في آن. ثم نهضت من المقعد وتركته في حيرة من امرأة تفر من أمومتها كمن تطاردها أفعى، لكن الرجل بما خبره كان متأكداً من شيء واحد: أن خراباً ما عصف بروحها.
كانت صفية تظن نفسها مختلفة عن بقية قريناتها، تحب المزاح والضحك بصوت عال، تقص شعرها رغماً عن والدتها المتعصبة، وتحتال عليها حتى تداري جريمتها أسبوعاً أو أسبوعين قبل أن ينمو مرة أخرى، فتكشفه أمها عندما تسحب المنديل فجأة من على رأسها، وتتجرع صدمة الشعر القصير، فتجري إلى الخارج لتحتمي بسطوة أبيها، فيضحك ويأمر زوجته أن تترك آخر العنقود لشأنها ولا تزعجها. تراقبها أمها من بعيد وتدعو لها بصوت مجلجل “الله ينجيكِ يا صفية.. قلبي راضي عليكِ من السما للأرض” فتطرب صفية من دعاء أمها وتركض مسرعة إليها لترتمي في حضنها، تتلقفها، وتباغتها بقرصة بين فخذيها، عقاباً على شعرها المقصوص، فتفر دمعة من الابنة الغرّة التي تراقب آثار تلك القرصة يوماً إثر يوم، حتى تختفي بعد فترة من الزمن.
تذهب مع أمها إلى الأعراس مخالفة العادات والتقاليد، تتشعبط في جلبابها وتبكي، تستجديها رؤية العروس، تنهرها مرة بسوط العيب، وتربت على كتفها مرة لتنسيها، إلى أن تنتصر رغبة صفية المكبوتة هذه المرة وترتدي فستانها القطيفة.
جدلت شعرها القصير في عُقْصَة تزينت بشرائط حمراء طويلة تنسدل على ظهرها الغض، لم تتهيأ للمفاجأة التي تنتظرها هناك، وهي تركض فرِحة في عرس ابنة خالتها، والتي ستقلب حياتها رأساً على عقب، ولا الحكايات التي ستخترق أذنها الصغيرة وتُنبت شوكاً أسود في صدرها طوال حياتها، شوك صبار سينمو دون حاجة للماء، يرتوي من خوفها الذي تعشش في ذلك النهار في صالة خالتها، أم العروس.
كانت صفية تتوسد قدم أمها وسط كومة من النساء المهنئات يجلسن على حصير يملأ أركان الصالة، في طرفه تجلس “عجيبة” سيدة نحيفة تتميز بالطول عكس معظم النساء في قبيلتنا، بشرتها حنطية، مائلة للسمرة، فيها جمال ساحر يجذب العين من أول وهلة، ويبدو أن لديها ما تحكيه من أمر جلل، فهمت ذلك صفية عندما رأت أعناق النساء تتوجه إليها، وكل واحدة منهن تسند وجهها على كفها. في هيئة ترقّب يرخين آذانهن وقلوبهن للحكي رغم صوت الغناء المبحوح الذي يأتي من الفرندة. تحكي “عجيبة” مأساتها الحية معها أينما ذهبت، مأساة بدأت فصولها بعد أجبرتها عائلتها على الزواج مرة أخرة بعد طلاقها، إذ لا يحق للمطلقة أن تنعم بحرية الاختيار، فأخذ طليقها السابق ابنتها منها عنوةً عندما علم بأمر زواجها، وَوضع ابنته في أمانة زوجته الجديدة فتربت ابنة ”عجيبة” على يد زوجة الأب، التي تعاملها كما يليق ببديلة الأم، كان الشقاء والعذاب من مصير الابنة إلى أن أتمت 18 سنة وأصبحت عروساً في سن الزواج، لكن دون زهوة الفتيات في مثل سنها، انطفأت فيها جذوة الشباب تحت نير خدمة البيت والغيط، أكلتها دوامة الأوامر وتدبير الحال، إلى أن جاء يومٌ متعوس، والتقت فيه الأم وزوجة الأب في مناسبة اجتماعية. وفي ظل تبختر زوجة الأب في وصلة قهر وغيظ للأم جاء نبأ دُسّ في أذن زوجة الأب فهبت مسرعة تاركة وراءها غيمة من التساؤلات والغمز واللمز، إلا الأم التي حست بثقل في صدرها وأن هناك خطباً ما. ترجّتها وركضت وراءها ماذا هناك، لترد عليها بغضب ظاهر لا شيء البتة، ليس لك دخل بشؤوننا، لكن الحقيقة أن النبأ كان يخصها والمصيبة مصيبتها، مصيبة الأم التي لم تدرك يومها أن ابنتها فارقت الحياة وهي تملأ المياه وتنقلها فوق رأسها وتحملها مسافة ثلاثة كيلو مترات، ماتت الابنة وآثار المياه تغمر جسدها.
وصلت إليها يد الغرباء أولاً وحُرمت من يد أم تطبطب عليها وتمسدها، كانت زوجة الأب أول الواصلين لتفتش في جسدها الميت وتتأكد من نظافته، حتى تدفع عنها ألسنة الحريم في الغسل، ولم تعرف الأم بوفاة ابنتها ولم يعلمها أحد حتى بعد أشهر من الحادثة، ورفضوا إخبارها بموضع قبر ابنتها، فتوسلت وقبلت الأقدام حتى وصفوا لها المكان الذي سكنت فيه ابنتها وأصبح بمقدورها أن تزورها بعد أن كانت محرّمة عليها.
كانت تحكي وتنوح وأخاديد حفرت على وجهها من وراء الدموع التي لم ولا تنضب، أجهشن النسوة بالبكاء في عز ظهر عرس ابنة خالتي.
من يومها، لم تفارق الصورة المتخيلة لملامح الفتاة الميتة عقل وروح صفية، وتحولت أحلامها إلى كوابيس، تفز منها فزعة مطلقة صرخات متتالية، وتجري على أمها تتلمس حبة الخال في خدها الأيسر لتتأكد أنهم لم يستبدلوا أمها بامرأة أخرى. لطالما اعتبرت صفية نفسها وهي ابنة خمسة عشر، أنها رسامة لغابة الحرية تزيح منها الفخاخ أمام بقية الفتيات، وتحرق أدغال الخراريف من أمامهن. كانت شخصيتها مثار حسد وغيرة، خاصة الصفة التي تميزها عن بقية شقيقاتها، وتضفي عليها الجاذبية، وهي قلة التأدب، بل انعدامه. تقول الحقيقة في الوقت الذي يجب فيه أن تتجمّل، وتعبد طريقا خاليا من الخداع وينتعل لسانها حجارة الواقع لتقذفها في وجوه النساء والصبايا عندما لا يعجبها أمر. لكن ذلك اليوم، يوم الحكاية، مَرّ بطيئا مشوشا على صفية، أكلها التفكير في النساء التي تُغتصب حياتهن ويفقدن بناتهن عنوة، وظل سؤالٌ واحدٌ يشغلها على مدى سنواتها، إذ لم تستطع الأم الاحتفاظ بابنتها فلماذا الخِلفة من الأساس؟ ولم الالتزام بسنة الزواج؟
نهشها الحزن ورافقتها الحمى. لا تشفى منها حتى تقع طريحة الفراش مرة أخرى. تعبت أمها من زيارة نساء القبيلة المداويات بالرقية وبالخزم والوشم، تنز عرقا في الشتاء والصيف، وأصبحت صفية نصف مجذوبة، تتدثر ليلاً بحكايا نساء وصبايا، قتلن ونهشن ومتن وحيدات، تصحو من نومها تحكي عن الفتيات التي يزرنها، لتخبر قصتهن بعد أن اجتثت ألسنتهن. كانت تزورها، كل فترة، فتاة مختلفة تسحبها من يدها. ابنة ”عجيبة“ المتوفاة زائرتها الأولى والدائمة، تأتي بها لصفية وتجلسها أمامها على مقعد بثلاثة أرجل لتحكي ما حدث في حياتها، وعندما يتركها الأموات يهتز جسدها في رعشات مزلزلة، وتنقلب عيناها حتى يظهر بياضها كاملاً وتختفي سمرتها، تستمر تلك النوبات لعدة دقائق، وقلب أم صفية وَجِل على البنت التي لم تعد ابنتها، وتبدلّت ملامح عينيها، فاختفت واحدة وبقيت أخرى، وانقلب حال لسانها فأصبح سليطا لا ينطق إلا عن حلكة حياة النساء في قبيلتها.
تصرخ في كل بطن منتفخة تصادفها بصوتها المبحوح “لا تنجبي بنتاً”، وتسرح بين المقابر ليلا عندما يرزح جسدها تحت الحمى لتكتب عليها بخطها المتعرج وبسرعة جنونية وهي تقبض بأصابعها على قطعة فحم، كأن روحاً من العالم الآخر تلبستها لتملي عليها عبارة ملأت بها شواهد الجبّانة “إن كان ثمة أمل، فهو في بطون نساء لم يولدن بعد”.